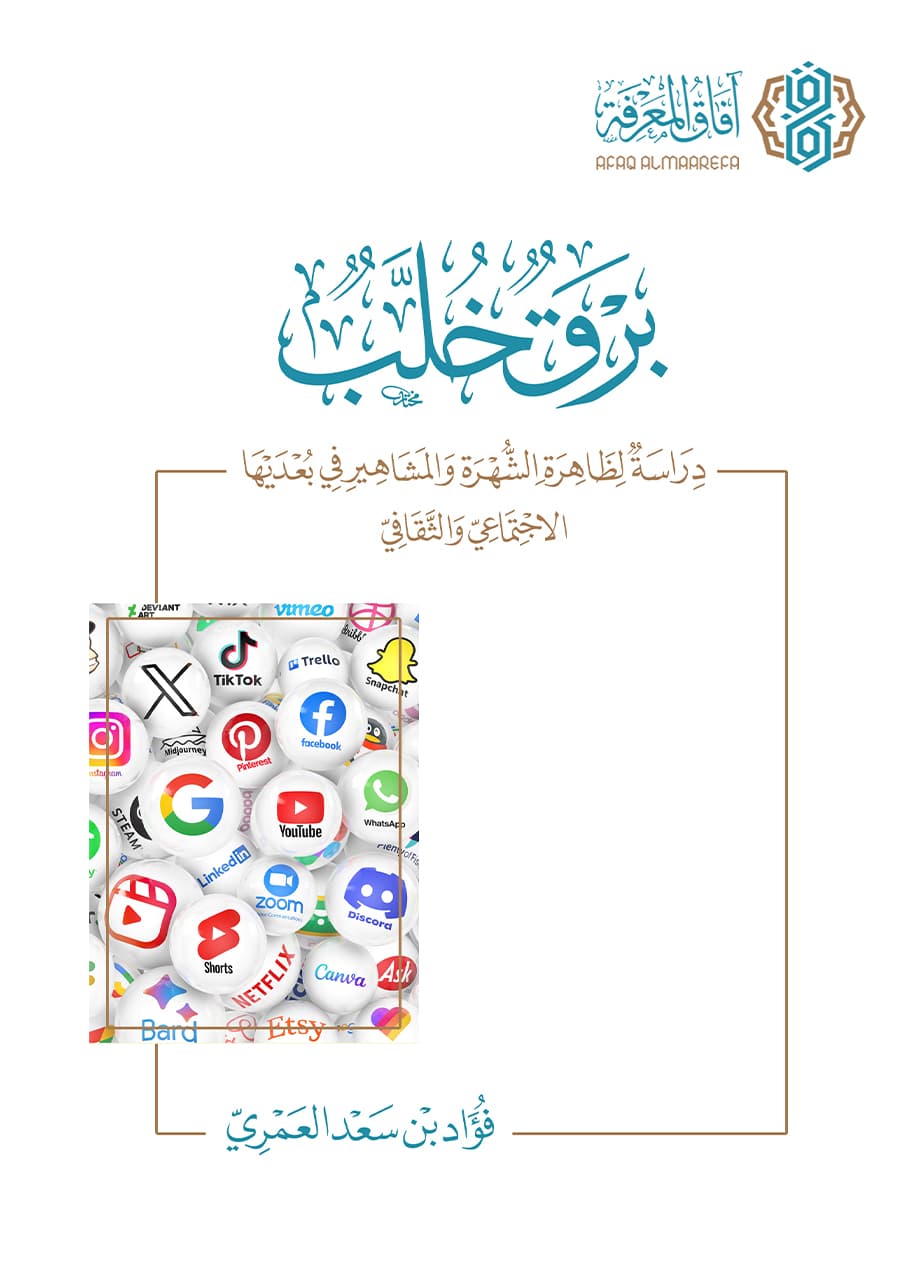
هذا الكتاب دراسةٌ متنوعةُ المداخل لظاهرة الشهرة، باعتبارها أحد المرايا التعبيرية الواضحة للحالة الثقافية المعاصرة، والتي تبيّن كيف أصبحت «ظاهرة الشهرة» أنموذجًا تفسيريًّا مثاليًّا لروح التدهور الاجتماعي. يقدم الكتاب تحليلًا لهذه الظاهرة ويكشف للقارئ عن مدى تجذرها في الرغبات البشرية الجامحة، ويعرض تفسيرًا لسطوة الشهرة واستحواذها على وعي واهتمام الجمهور والبروز الثقافي المفرط للمشاهير، مع بيان ما تضمَّنه ذلك من مشكلاتٍ شرعية وثقافية واجتماعية. وأظهر الكتاب تمدُّد الظاهرة واتساع دائرة تأثيرها، بدءًا من انعكاسها على مجتمع الشهرة المصغر، ثم على مختلف الروابط الاجتماعية، وكذلك القوانين الاجتماعية والأنساق الثقافية، والمدى المتصل بالحالة الدينية العامة، وما يتبع ذلك من تحولات يتسع مداها لتصبغ الحالة الإنسانية بكل تشكلاتها.
356 صفحة

112 صفحة
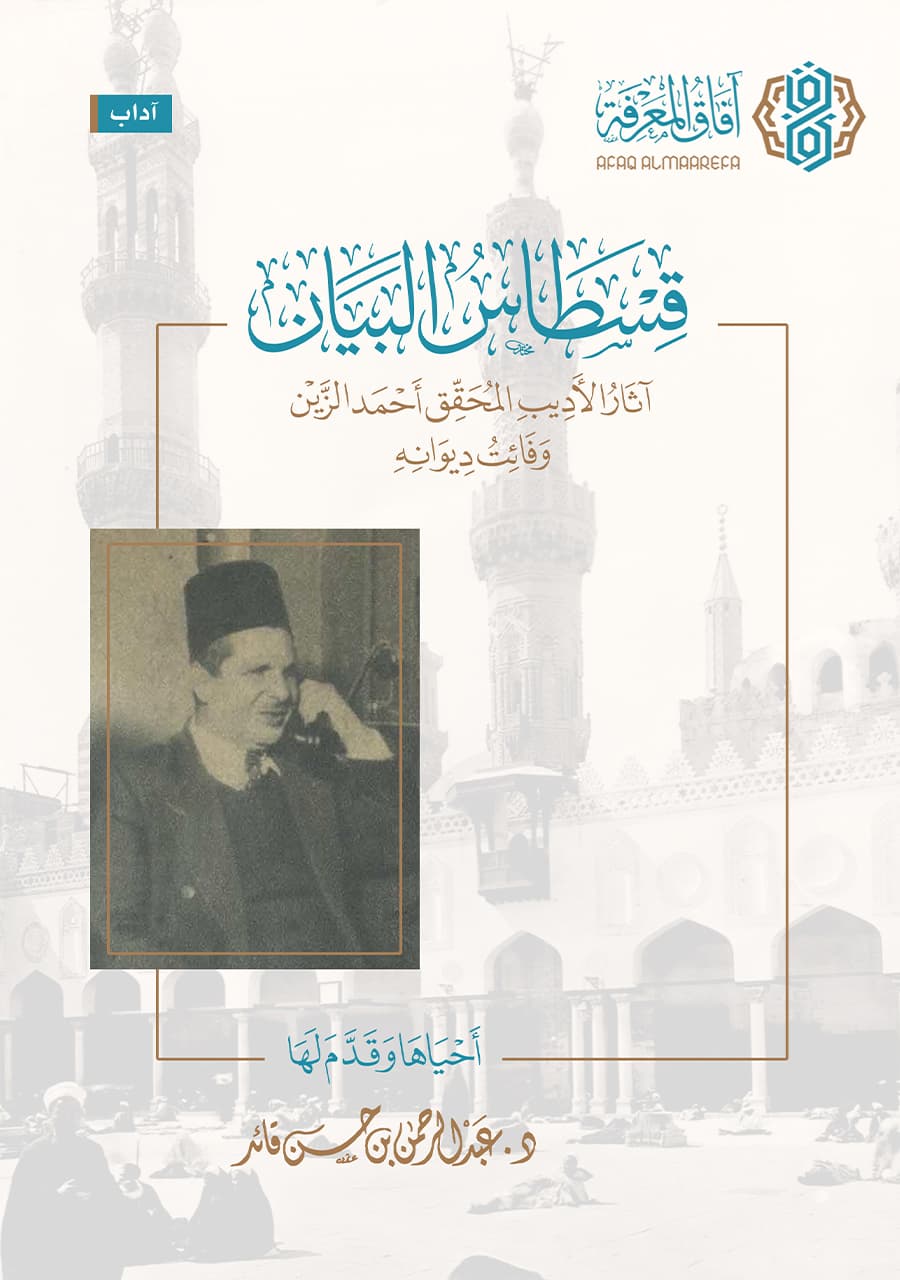
هذا كتابٌ كان ينبغي أن يظهر قبل أكثر من ثمانين سنة، لكاتب عرفه معاصروه شاعرًا فحلًا، وناقدًا حاذقًا، وراويةً ظريفًا، ومحققًا بارعًا، وأديبًا يملأ سمع الدنيا وبصر الأيام، ثم مضى كما تمضي كواكبُ الأسحار خِفافًا سِراعًا خافتة الضياء، فنسي منه الناسُ أكثر ما كانوا يعرفون، وسقط من كُمِّ التاريخ فلم يأبه لسقوطه العابرون، ولم يكد يبقى بين أيدي القرَّاء منه إلا اسمٌ موضوع على غلاف كتاب تراثيٍّ يمرُّون عليه وهم عنه معرضون، وأبياتٌ من كرائم شعره يتناشدها رواةٌ عن رواة لا يذكرون، ودراساتٌ نزرة مغمورة أخنت عليها السِّنون، ثم لا شيء غير الصمت المطبق والغياب البعيد. أحييتُ فيه آثار العالم الراوية الشاعر المحقق الناقد أحمد الزين رحمه الله، وفيها خمسون مقالًا رائقًا في الأدب والنقد ومتخيَّر البيان، وثمان مقدمات عالية لتحقيقاته، ونحو أربعمئة وعشرين بيتًا خلا منها ديوانه المنشور. وقدَّمت بين يديه دراسةً جامعة فريدة عنه هي كتابٌ قائمٌ برأسه، تنصفه بعض الإنصاف، وتؤدِّي إليه بعض الحق، وتكون مرجعًا لمن شاء أن يعرفه من قريب، ومتاعًا لمن أحبَّ أن يُشْرِفَ من كوَّة صغيرة على تاريخ الأدب في النصف الأول من القرن الماضي بمصر. ولئن كان «من ورَّخ مؤمنًا فكأنما أحياه» كما يقول أبو العباس المَيُورْقِي، فأحسب أن من ورَّخه وأحيا آثاره قد خلَّد ذِكره. الفهرس والمقدمة
558 صفحة

318 صفحة

تمارس الشركات متعددة الجنسيات أدوارًا مهمة في تشكيل الاقتصاد العالمي ويمتد أثرها ليشمل مساحات شاسعة من خارطة العالم، ومع ذلك فليس هناك سوى القليل من الدراسات التي تدرس ذلك وترصد تأثيرها في صنع السياسات الخارجية. ومن هنا تتمثَّل المساهمة الرئيسية لهذا الكتاب في التحقيق في الأدوار المميزة للشركات متعددة الجنسيات كجهات فاعلة سياسية، وتسعى هذه الدراسة في الإجابة عن حزمة من السؤالات التي من شأنها أن تكشف عن نطاق تأثير هذه الشركات، ومن تلك السؤالات: هل تختلف الشركات متعددة الجنسيات عن الشركات الأخرى في أنشطتها السياسية؟ هل تؤدي الروابط العالمية لهذه الشركات إلى الحصول على تفضيلات سياسية متميزة من الشركات المحلية؟ هل تختلف الأنشطة السياسية للشركات متعددة الجنسيات عن أنشطة الشركات المحلية الكبيرة؟ وغير ذلك من السؤالات التي تبصِّر القارئ بواقع هذه الشركات وسياساتها، وقبل ذلك يقدم هذا الكتاب إلى قارئه جملةً من المعارف المهمة حول مفهوم هذه الشركات وخصائصها وصلتها الوثيقة بتاريخ الاستعمار والإمبريالية. المقدمة والفهرس
210 صفحة

ليست الغنوصية بالموضوع الجديد على المكتبة العربية؛ وحتى وقت ليس ببعيد، كانت جلُّ تصوراتنا عن الغنوصية مستمدةً من الكتابات الدفاعية التي صنفها آباء الكنيسة في الرد على الهرطقة الغنوصية. وتحوي هذه الكتابات خلاصات عن عقائد الغنوصيين وكتبهم وأعلامهم، أما نصوص الغنوصيين أنفسهم فكانت في عداد المفقود حتى وقت قريب. ولم يكن ثمة جديد يمكن إضافته على ما هو موجود في تلك الكتابات الدفاعية بسبب عدم وجود مصادر أخرى. والباعث على ترجمة هذا الكتاب ما تضمنه من إضافةٍ للمكتبة العربية، وذلك في نقطتين: الأولى: رصده للانشقاق المنهجي الحادث داخل أروقة الأكاديميات وكيف انعكس على دراسة الغنوصية؛ وفي هذا الصدد لا يكف المؤلف عن تكرار الصدع المنهجي في دراسة الغنوصية الذي أقام «غنوصيتين» وليس غنوصية واحدة؛ الأولى هي الغنوصية باعتبارها ديانة تاريخية، وأما الثانية فهي ما سماه «الغنوص» أو المعرفة الغنوصية؛ وهو ما اعتبره عددٌ من الباحثين «جوهرًا» خالدًا متجاوزًا للتاريخ، أو هو بالأحرى نوعٌ من الممارسة الدينية الباطنية، قد توجد في أي زمان ومكان. الثانية: تتبع المؤلف لعدد من الجماعات الغنوصية المعاصرة التي ظهرت في الغرب محاولًا تتبع الطرق التي تربط من خلالها هذه الجماعات نفسها بالغنوصيين الأوائل.
366 صفحة
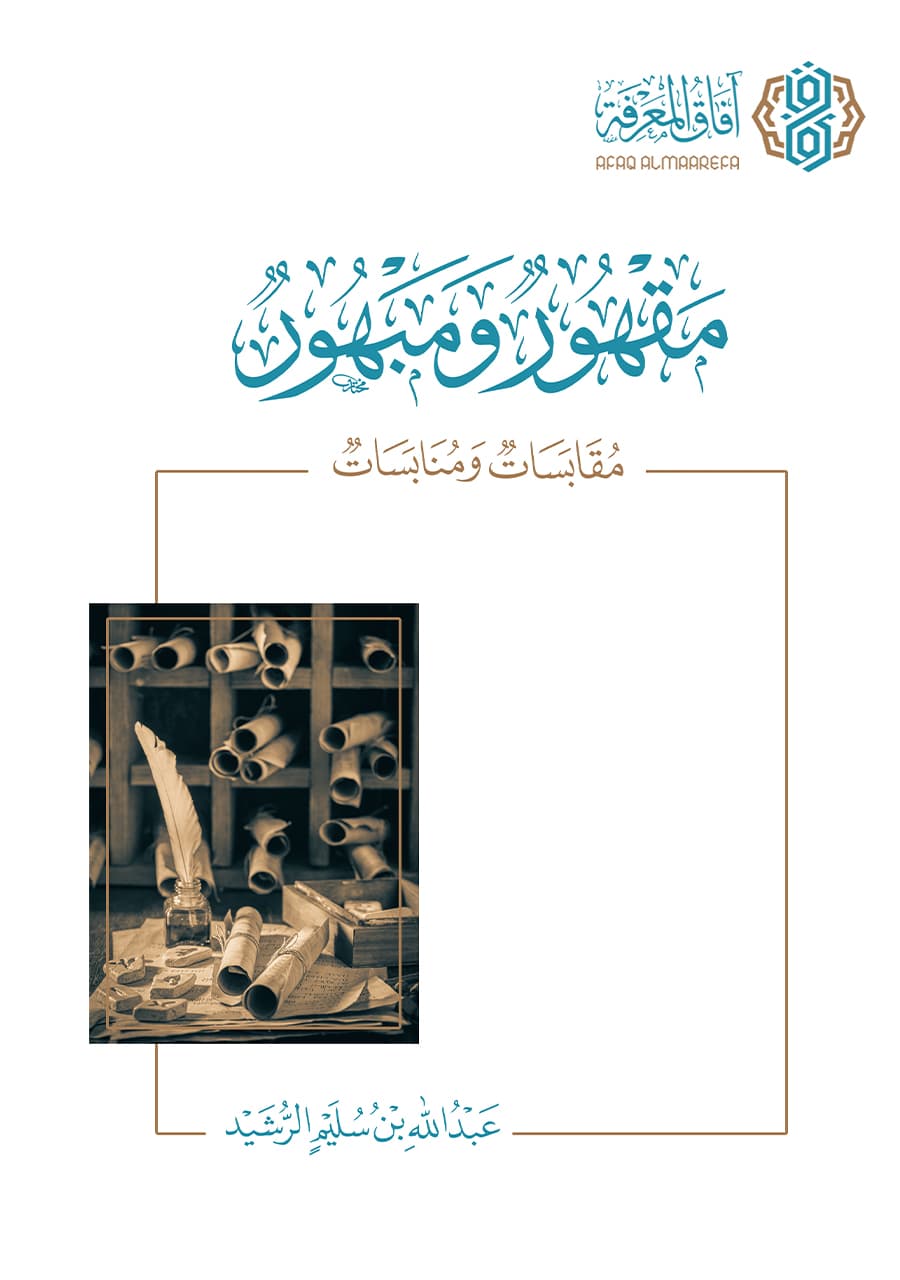
الأدبُ طبقات، ولكلِّ طبقةٍ أهلُها، وقد تجتمع طبقاتٌ عدّة عند منشئٍ واحد، واضربْ بعينك حيثُ شئتَ في دواوينِ بعض الكبار، تجدْ قصائدَ ذاتَ طُعوم، وإنشاءً يُعليه قارئٌ، وينظرُ إليه آخرُ شَزْرًا، وليس على الراضي عتابٌ، ولا على الساخطِ ملامةٌ؛ فلكلٍّ أن يستحسنَ ويستقبحَ، ما اتّكأ التلقّي على أصولِ المعرفة الضرورية بالأدب، ولا سيّما الشعر. ومع هذا أقول: آنَ للمرقَسِيِّينَ أن يحترموا أذواقَ الرَّبَابِيِّين، الذين تُطربُهم (رَبَابةُ ربّةُ البيتِ)، ويُبَهْرِجون (قفا نبك). ولْيَبْكِ المراقسةُ ما شاؤوا (بسِقْطِ اللِّوى بين الدَّخول فحَوْملِ)، ولْيهنأْ أولئك بصياحِ (تسعِ دجاجاتٍ وديكٍ حسنِ الصوتِ). هذا الكتابُ سعيٌ إلى النزول من البرجِ العاجي، بتقديم الأدب الفصيح لطبقات متعدّدة، ولعله يُستمالُ به الكاشحُ، ويُرضَى الغاضبُ، ويُردُّ الشاردُ. وهي محاولةٌ خطِرة جدَّ الخطر؛ لأن المؤلفَ موقنٌ بسلوكِه دربًا كثيرَ العثرات، تتخطّفُ طُرّاقَه خطاطيفُ النقد، وكلاليبُ الآراء، ولكنّه مع ذلك مُقدِمٌ، مُنَكِّبٌ عن ذكر العواقبِ جانبا. ومن لم تعجبْه مائدةُ هذا الكتاب، فلْيَعْدُدْ ذلك تقصيرًا من المؤلِّف في ضيافته، لا عجزًا من الأدب الفصيح، ولْيحكمْ بضيق ذات يدِ المؤلِّف، لا بقِصَر باعِ الفصحى.
374 صفحة
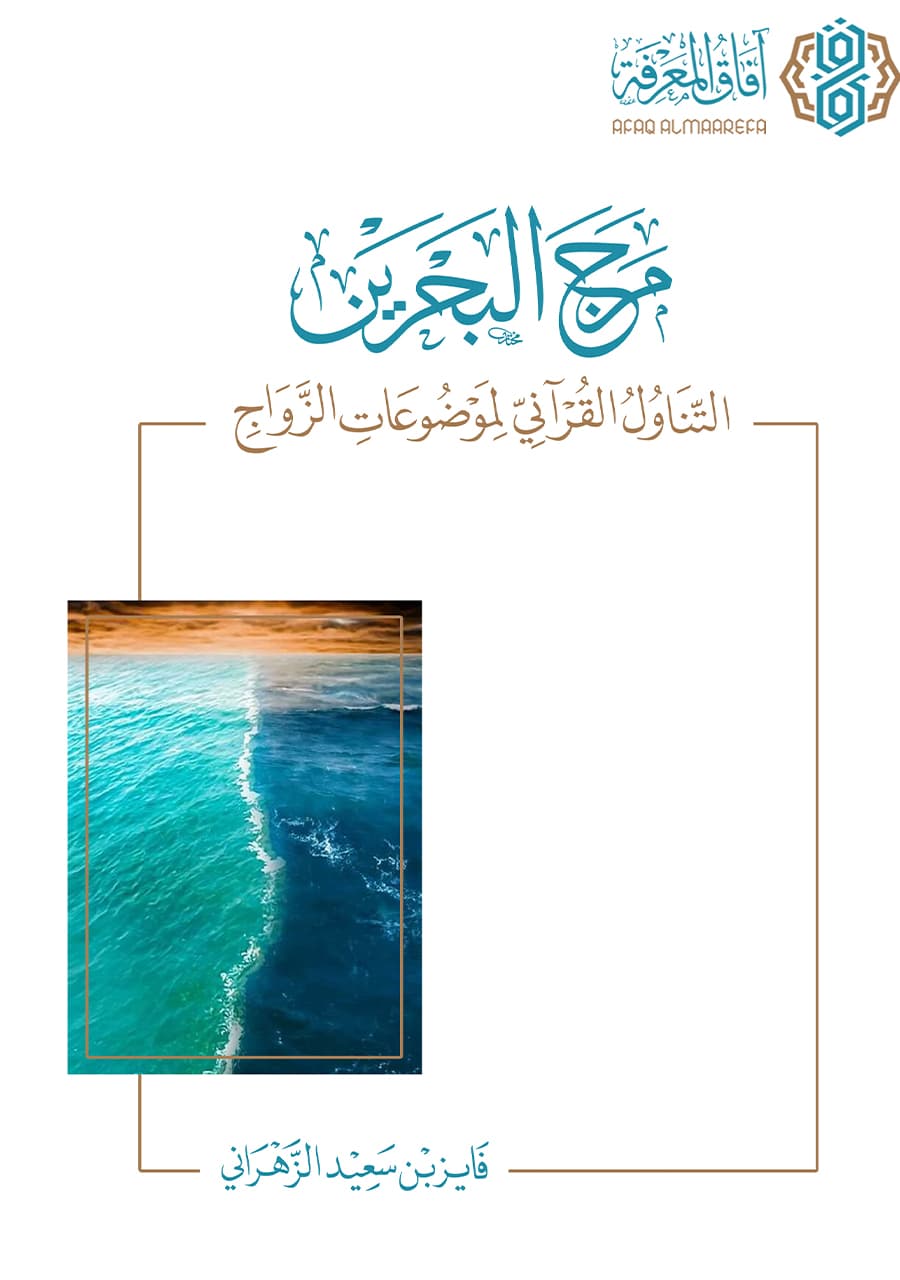
في أول أيام الدنيا ..لم يأنس «آدم» في الجنة، وهي الجنة!حتى تزوج بـ«حواء»، فأوى إليها، وأنِس بها. { اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ }. ومنذ ذلك الوقت كان الزواج من أهم ركائز الاستقرار في الحياة .. ولا يزال .. على الصعيد الفردي، وعلى صعيد المجتمع، وعلى صعيد الأمة، وعلى صعيد العالم، وعلى صعيد الكائنات. إنه ناموس كوني عظيم، صنعه العليم الحكيم. وبين يديك «مرج البحرين» يحاول المؤلف فيه تأمُّلَ الطريقة التي يعالج بها القرآن الكريم موضوعات الزواج، بغرض الاستهداء والتعلُّم، فللقرآن طريقته الأخَّاذة، الممتلئة حكمة وجمالًا، المتفردة في البيان والتوضيح.
230 صفحة
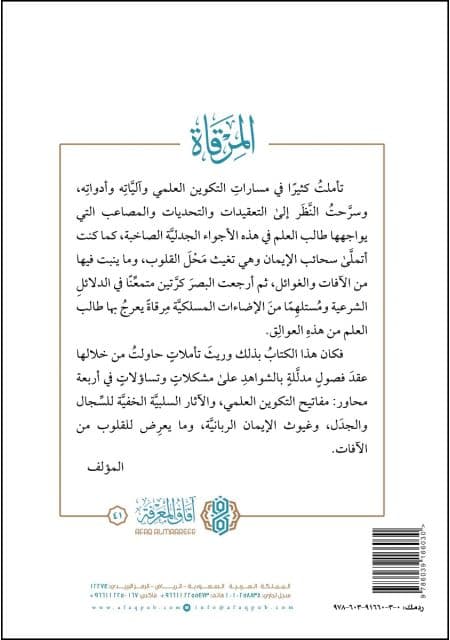
كتاب كتاب
غير محدد صفحة

قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ يؤسس لأصل شرعي في تحرير المفاهيم، والخطاب بالمصطلحات التي تعبر عنها بدقة، من غير التباس، ولا تشبه بما يخالف تميز المسلمين. وإذا كان الله تعالى في هذه الآية ونظائرها أولى اختيار المصطلح للمفهوم وسياقه عناية كبيرة فإن هذا يدل على أن هذه القضية ترتقي إلى سلم الأولويات في الفكر الإسلامي. وما الصراع الحاصل بين الإسلام منذ رسالة النبي # الذي جاء بتصحـيح مفهـوم العبـوديـة لله، وبـين المذاهــب والأفكــار المضــادة له إلا صراع بين المفاهيم. وهذا الصراع يجعل المصطلحات والمفاهيم الإسلامية بين خطاب سائد أو مضاد، فربما كانت مفاهيم الإسلام هي السائدة في بلد أو في زمن، وربما كانت غيرها. وفي هذا الكتاب بيانٌ لأهم الآليات التي ساد بها خطاب الإسلام بمصطلحاته ومفاهيمه، بعد أن كان خطاب الشرك هو السائد بمصطلحاته ومفاهيمه، ثم الآليات التي يستخدمها الخطاب المضاد للإسلام؛ لتنحية مصطلحاته ومفاهيمه، وترسيخ ما يضادها.
174 صفحة

من المسائل الكبرى التي ضلَّت فيها الحضارة الغربية وأضلت بها تعريف المرأة، من هي؟ وما حق الله عليها؟ وما وظيفتها في الحياة؟ وما مسؤولياتها؟ وما الفرق بينها وبين الرجل؟ وما علاقتها به؟ وما موقعها في الحياة الزوجية؟ ونتيجة هذا الضلال كانت خطرة، حيث أتت على أصول مهمة في الشرائع فألغتها وأتت على محكمات الدين فكسرتها. ولقد جاء القرآن الكريم بأحسن تعريف للمرأة، وأجمله وأكمله، وكرَّمَها وأعلى منزلتها، كما أجاب عن سؤالاتها القديمة والمعاصرة، واتخذ لذلك عدة أساليب، ومنها ما تضمَّنه من قصص النساء اللاتي اختارهن الله أنْ يكنَّ قدوات صالحات للمؤمنات، من الأمم الماضية ومن هذه الأمة، وتجد كل قصة تحمل عددًا من الدروس والمفاهيم التي يجب فهمها والعمل بها، وبمجموع تلكم القصص تستطيع المؤمنة أنْ ترتقي بمفهومها عن المرأة لأنها قصص ربانية، والله تعالى لا ينزل إلا أحسن القصص رواية وعبرة وفائدة. وهذا الكتاب يستعرض تلك الإجابات القرآنية عن سؤالات المرأة، من خلال قراءة قصص النساء في القرآن واستلهام الدروس والمفاهيم المضمنة فيها.
218 صفحة

النظام الإيراني نظرة من الداخل
177 صفحة

بدريونتراجم علمية وتربوية مختصرة لأهل بدر رضي الله عنهم هذا الكتاب فصلٌ مهمٌّ من فصول السيرة النبوية؛ فهو يدور حول غزوة بدرٍ، وإن لم يتعرض للغزوة بالتفصيل، وهو مختصرٌ في السير والتراجم، حيثُ ترجم لصحابةٍ شهدوا غزوة بدر، وإن لم يستقصِ كلَّ جوانب من تُرجم له، بل ركَّز على وقفات ومعالم فيها. (بدريون) محطات (إيمانية) ووقفات (علمية) ولفتات (تربوية)، والمؤمل أن يجد فيه المربي مادةً تُعينه على التربية، ويجدَ الخطيبُ فيه وقفاتٍ تسعفه في كتابة الخطبة، كما هو مؤمل أن يجد فيه الباحث ما يفيده، والقارئ مادةً لسلوته مع النفع والفائدة. والكتاب موثَّق في مادته العلمية حيث يعتمد المصادر الأولى من كتب السنة والسيرة النبوية، والطبقات والتراجم ونحوها. وهو مختصر بحيث يكون في متناول طالب العلم المبتدئ، والصغير والكبير، والذكر والأنثى. وهذه النشرة الجديدة الصادرة عن مركز آفاق المعرفة للبحوث والدراسات تشتمل على الجزأين اللذَين سبق نشرُ كلِّ واحدٍ منهما استقلالاً، فكانت بذلك متضمنةً لمئة وسبعة (١٠٧) تراجم.
390 صفحة
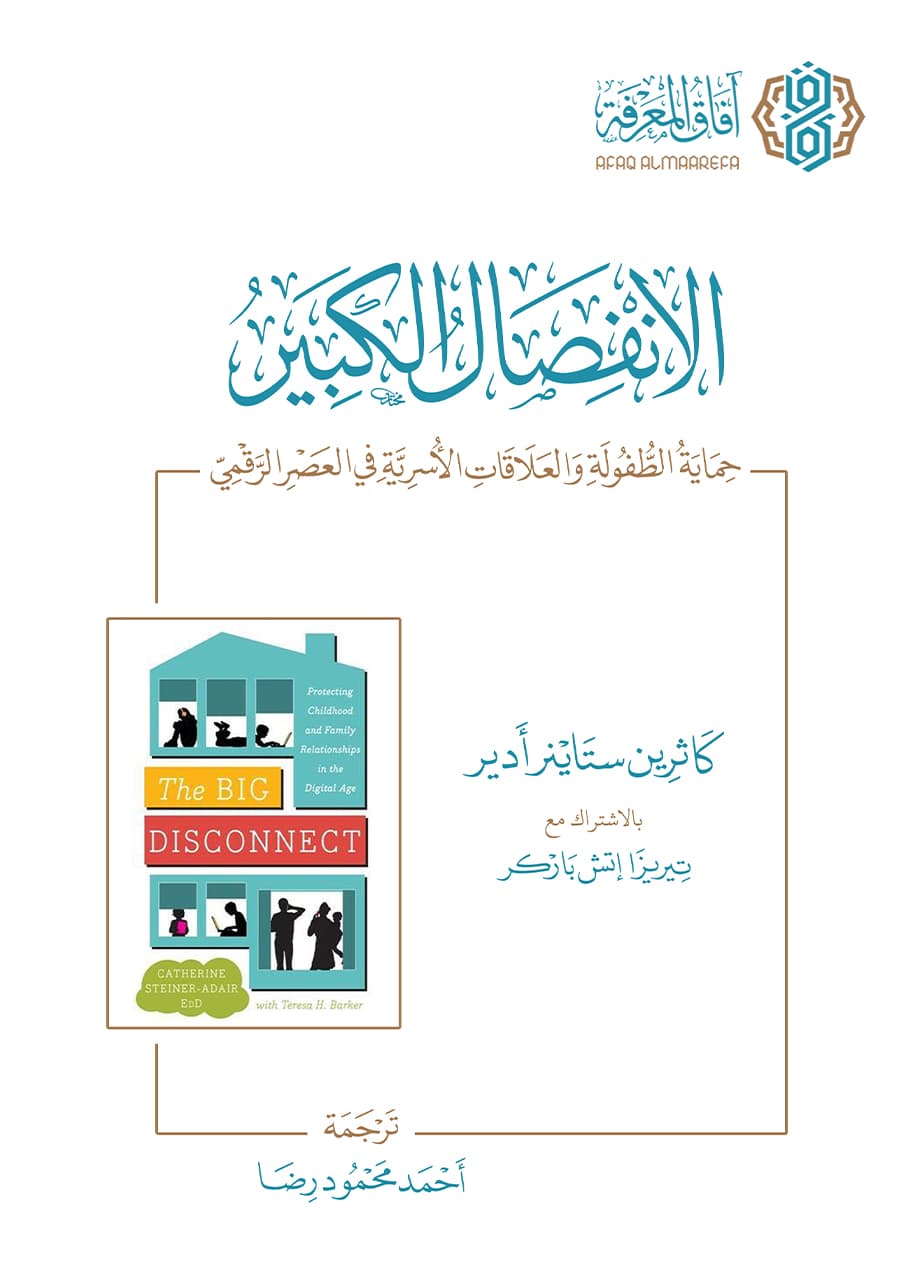
يشهد واقع الأسرة اليوم تحولًا جذريًّا مع تحول تركيز الأسرة إلى الشاشات؛ فالأطفال يرسلون رسائل نصية طوال اليوم إلى أصدقائهم، أو يدخلون على الإنترنت لأداء واجباتهم المدرسية، بينما الآباء يعملون على الإنترنت على مدار الساعة. لقد أدى الوصول السهل إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى محو الحدود التي تحمي الأطفال من التعرض لما يضره، وغالبًا ما يشعر الآباء بأنهم يفقدون تواصلهم الفعال مع أطفالهم، بينما يشعر الأطفال بالوحدة والاغتراب. لقد وُلد العالم الرقمي ليبقى، ولذا فالسؤال الأهم هو ما الذي تخسره الأسرة مقابل مكاسب التكنولوجيا؟ توضح عالمة النفس الشهيرة كاثرين ستاينر أدير أن الأسر في أزمة وأمام مأزق أكبر مما يتصورون، لا تخلف عوامل التشتيت المزمنة للتكنولوجيا وراءها آثارًا عميقة ودائمة فحسب، بل يحتاج الأطفال أيضًا بشدة إلى الآباء لتوفير ما لا تستطيع التكنولوجيا توفيره؛ ألا وهو التفاعلات الوثيقة والفعّالة مع البالغين في حياتهم. واستنادًا إلى قصص واقعية من عملها السريري مع الأطفال والآباء وعملها الاستشاري مع المعلمين والخبراء في جميع أنحاء العالم، تقدم ستاينر رؤى ونصائح يمكن أن تساعد الآباء على تحقيق قدر أكبر من الفهم والثقة أثناء تفاعلهم مع الثورة التكنولوجية التي تتكشف في غرف المعيشة اليومية.
480 صفحة

321 صفحة
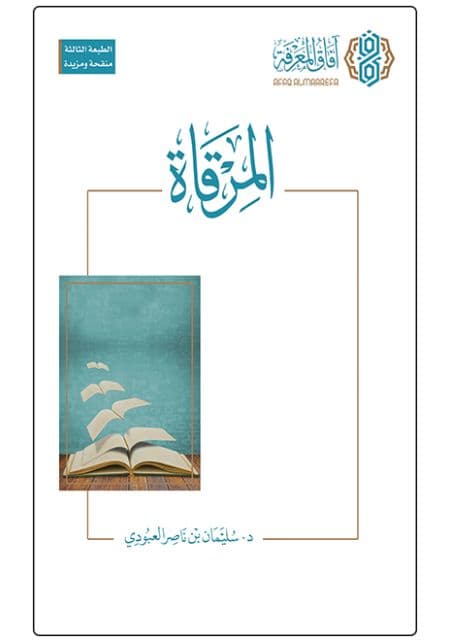
غير محدد صفحة

بعد أن شرَّقت المجموعة الأولى من كتاب «الظل والحرور» وغرَّبت، ها هي المجموعة الثانية تأتي بعد طول انتظارٍ، وقد عانى فيها مؤلفها أضعافَ ما عاناهُ في المجموعة الأولى، لأن عيون السيَر الذاتية قد تقدَّمت في المجموعةِ الأولى، وما تبقَّى فإن أغلبه من السير المغمورة، ولذا كان الاختيار منها صعبًا. ومع ذلك فقد تضمنت هذه المجموعة منتخَبَاتٍ مبوَّبةً من 140 سيرةً ذاتيةً، وقد أوفى حجمها على المجموعة الأولى، واحتوت من الفرائد والفوائد على ما يُمتِع ويُؤنِس، فكانت هذه المجموعة بحقٍّ سفرًا ثانيًا من مكتبة الحياة، وصُبابةً أُخرى من ذاكرة الأيام، وآثارَ خطواتٍ على طريق العُمُر، وينابيعَ من الحزن والمَسرَّة، وسَيْرًا في منازل الخُطَى الأولى، وشدوًا من أغاريدِ الطفولة ودهشةِ الصِبا. إن حكاياتِ المُصابرة والمُجالدة، وقصصَ النجاح والطموح، وآثارَ الإحسان والمعروف، وعاقبةَ المكر والظلم، إنَّها كلَّها من العِبَر الإنسانية التي يَحْسُنُ أن يُكشَفَ أمرُها للناس؛ لتواسيَهم وتؤنِسَهم وتكونَ علاماتٍ يهتدون بها في دروبِ الحياة .. وهو ما نرجو أن يقدمه هذا الكتاب الفائق لقارئه ويفتح له نافذةً يرى منها حوادثَ الأيامِ وعِبَرَ السنين وخُلاصةَ العمر وصروفَ الزمان؛ ممَّا قد يُخَفِّف عنه بعضَ الأسى والألم، ويثير في نفسه شيئًا من بواعث الرضا والسرور وشُكرِ النِعَم
698 صفحة
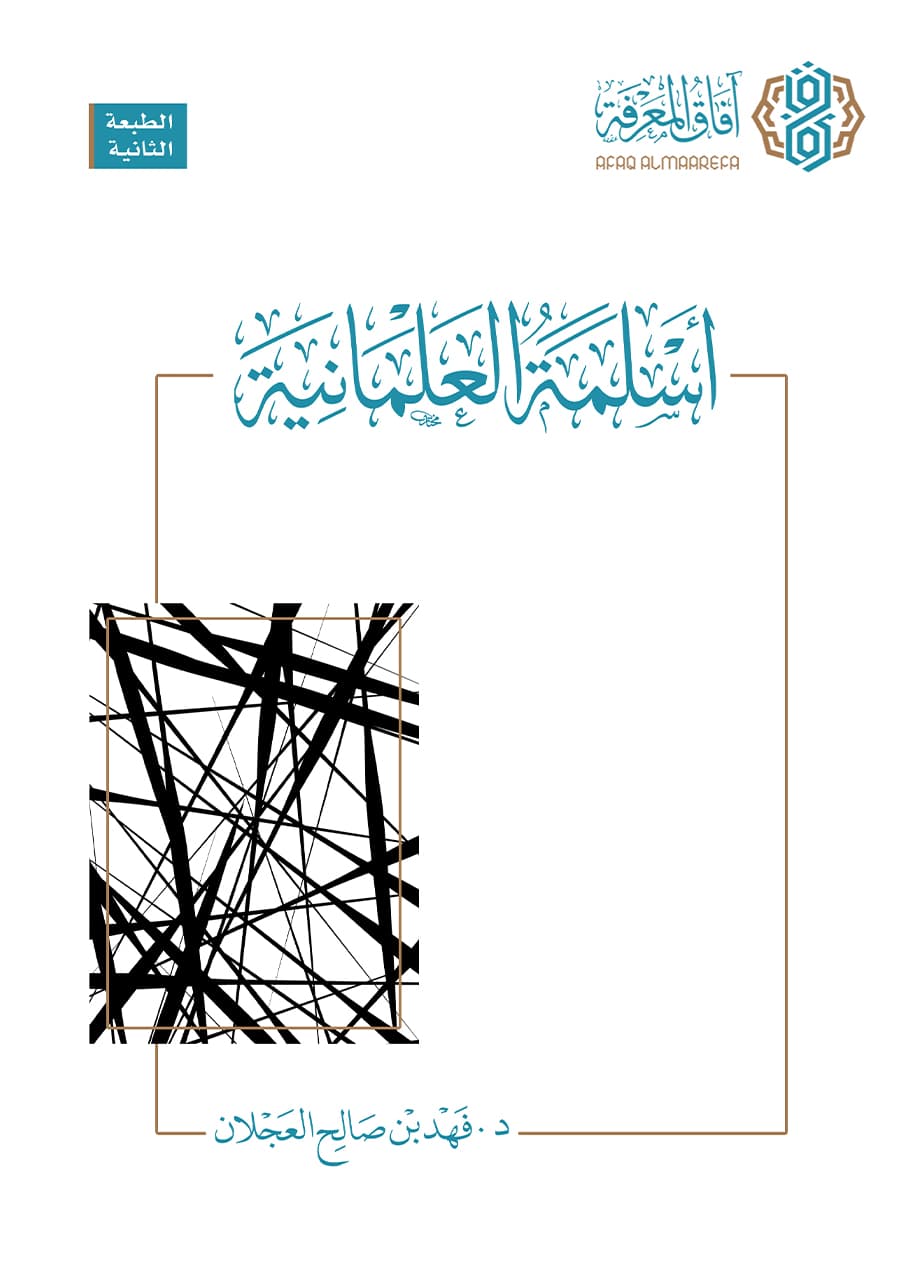
يتحدَّثُ هذا الكتاب عن ظاهرةٍ معاصرةٍ تسعى لعرض أحكام الإسلام ونظامه العام بما لا يتعارض مع الجانب السياسي للعلمانية، فهي تؤمن بمرجعية الشريعة وحكم الإسلام، لكنَّها تسعى لأن يكون هذا كله غير متعارضٍ مع العلمانية. عرض الكتاب لمقولاتٍ كثيرةٍ تسعى لتحقيق هدف أسلمة العلمانية، يجمع هذه المقولات أنها: طريقةُ نظرٍ أو مسلكُ استدلالٍ يرفع ما في الأحكام في الإسلام من الإلزام المستند إلى الأصل الديني، حتى يبدو النظام السياسي في الإسلام غير متعارضٍ مع الجانب السياسي للتصوُّر العلماني. في هذا الكتاب عرضٌ نقديٌّ لهذه المقولات، وبيان ما فيها من إشكالاتٍ، وحديثٌ مفصَّل عن ظاهرة التصالح مع العلمانية، والأفكار المحفِّزة لها، مع مقدمةٍ لا بدَّ منها للأصل الشرعي المتعلِّق بسيادة الشريعة، والأفكار المزاحمة لها.
274 صفحة

التوظيف العلماني لأسباب النزول دراسة نقدية للدكتور أحمد قوشتي عبدالرحيم تسعى هذه الدراسة لتتبع مواقف العلمانيين العرب، وكيفية توظيفهم لباب «أسباب نزول آيات القرآن الكريم»، والذي تعاملوا معه - مثل غيره من علوم الإسلام - بصورة انتقائية، واتخذوه غطاء يمررون من خلاله أفكارهم، وآراءهم، حول الدين، والوحي، والنبوة، والقرآن، وأحكام الشريعة، ومن ذلك: القول بتاريخية القرآن، وأنسنته، وبشريته، وتأثره بالواقع الذي نزل فيه، وأولوية الواقع على النص، وعدم صلاحية الأحكام الشرعية للتطبيق في كل زمان ومكان، وما أشبه ذلك من الأفكار المنحرفة، التي عرض لها البحث مع بيان تهافتها، ونقدها نقداً علمياً.
277 صفحة

كيف نجعل من بيوتنا سكنا؟
140 صفحة

تلاد الإعجازقراءة تحليلية لأوجه الإعجاز القرآني في ضوء آثار السلف الصالح من أعظم غايات إنزال القرآن الكريم على البشرية الإيمانُ بكماله وعظمته، وأنه من عند الله الحكيم الخبير، ومن أقوى وسائل إدراك ذلك: الوقوف على شواهد الإعجاز ودلائله التي اتسمت به آياته والتي كشفت عن عجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله أو بشيء منه، وذلك ما تكفَّل بإبرازه: علمُ إعجاز القرآن الكريم، والذي تتجدد الحاجة إليه في كل عصر، وعَظُمت في هذا الزمن لظهور موجات الإلحاد شرقًا وغربًا، وكثرة الشك والشبهات التي ظهرت على الساحة هذه الأيام، والتي تستوجب إمداد الأجيال الناشئة والقائمين على تربيتهم وتوجيههم بالمعارف القرآنية الكاشفة عن خواص كتاب الله عز وجلَّ وما تضمَّنه من أنوارٍ ورسالات. ولأنَّ جملةً من مقالات المتأخرين المصنفين في الإعجاز داخلها شيءٌ من التكلُّف في تقرير معاني الآيات واستنــطاق دلالات الإعــجاز فيها = عُنِيَ هذا الكتاب باستحضارِ بيان السلف من الصحابة ومن بعدهم لمعاني الآيات المتصلة بوجوه الإعجاز، مع التعليق عليها وإبراز جوانبها الإيمانية والبيانية من كلام المفسرين والعلماء المحققين؛ فكان جوهر هذا البحث عائدًا إلى رياضِ السلف الصالح وتلادِهم الأصيل، حيثُ كانوا أبرَّ الأمة قلوبًا، وأعمقَ علمًا، وأقل تكلُّفًا، وأقربَ إلى أن يوفقوا.
130 صفحة

كان موضوع الصفات الخبرية -التي دل عليها الكتاب والسنة، ولم تعلم بالعقل- معتركًا بين الطوائف، ومحلًّا للتجاذب، بين مثبت ومفوّض ومؤول، وملئت كتب التفسير وشروح الحديث من ذلك، واختلطت الأقوال، وتداخلت الأدلة، وتشعب الخلاف، وكثرت الدعاوى، فمسَّت الحاجة إلى جمع ما يتصل بهذه الصفات، فأتى هذا الكتاب وسعى في تحرير كلام المتقدمين والمتأخرين عليها، والوقوف على الأدلة العقلية التي صرفت أكثر المتكلمين عن إثبات هذه الصفات، وتحقيق القول في مذهب السلف، وبيان الفرق بينه وبين مذهب الخلف، وتأصيل القول في حجية الأدلة النقلية، واعتماد الظواهر أو نفيها، وما يتصل بذلك من المباحث والمسائل.
506 صفحة
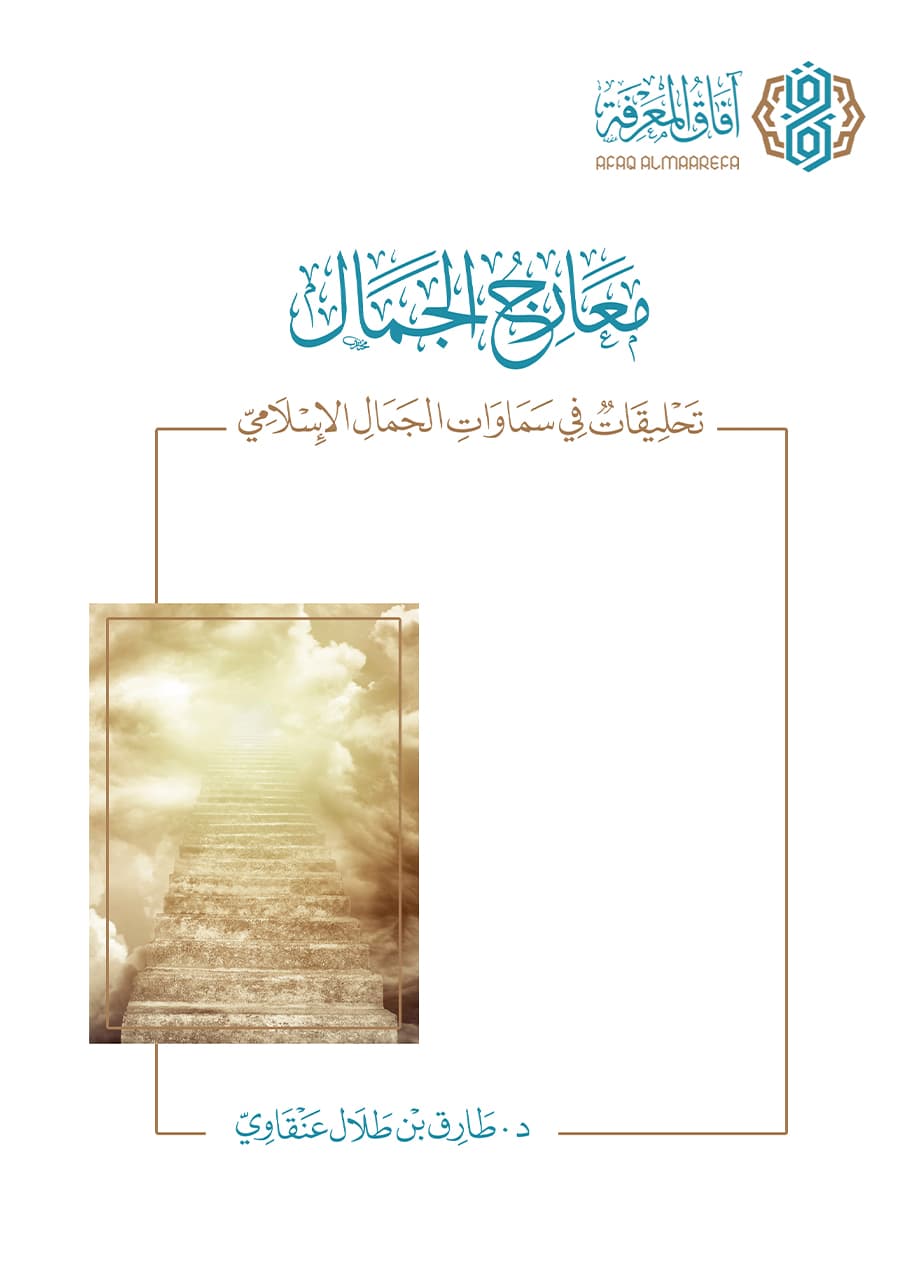
لكلمة الجمال وقع جميل، فقد فطرت النفوس على حبّ الجمال، وتعرّف الله تعالى إلى عباده باسم الجميل، وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، وكفى بذلك مزيَّةً ومنزلةً للجمال، وقد جُعِلَ باعثًا وحاديًا إليه تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يعرج بنا في مراقي الجمال ومعارجه عبر رحلات متعاقبة يتكامل بمجموعها تصورنا حول مظاهر الجمال في الإسلام، حيث يبتدئه المؤلف بالحديث عن الجمال في الإسلام مبينًا منزلته وأهميته لعصرنا، ثم يتناول بالبحث جمالَ التصورات الكبرى، وجمالَ العلاقة بالله تعالى وما تثمره في نفوسنا، ثم يلي ذلك الكلام عن جمال النبوة وما تضمنه من تقرير العناية الإلهية بالبشر، ثم يطوف بنا حول جماليات الأخلاق والتشريعات. وقد نظم المؤلف ذلك كله بطريقة جميلة مشوقة آخذةٍ بحبلٍ من التأصيل وآخر من التطبيق.
178 صفحة

أثرٌ ذهبيٌّ جديدٌ ينشر أول مرة من آثار الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748، جمع فيه طائفة مما ورد في فضائل البلدان من الأحاديث والآثار، موشَّاة بأحكامه المحكمة، وعباراته الفائقة، وتعليقاته البارعة، انتخبه من خطه الحافظ المحدث أحمد بن أيبك الحسامي المعروف بابن الدمياطي المتوفى سنة 749، وزاد عليه زيادات مفيدة في بابه، حققته عن نسخة فريدة بخط ابن الدمياطي، وقدَّمت بين يديه بدراسة موجزة نافعة عن كتب فضائل البلدان ومظانِّ أحاديثها، والتساهل في روايتها، وأسباب كثرة الوضع فيها، وحقيقة تفضيل الأمكنة والبقاع ومذاهب الناس في ذلك، ثم عرَّفت بالكتاب موثقًا نسبته إلى مؤلفه، وموضحًا منهجه، ومترجمًا لناسخه وراويه، وواصفًا للأصل الخطي الذي اعتمدت عليه في نشره.
202 صفحة

غير محدد صفحة

من الأعمال البحثية المميزة تلك الموسوعة الموسومة بـ «موسوعة الإجماع»، وهي من المشاريع البحثية الضخمة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض، وتعتبر مشروعًا علميًّا يمثل نقلةً نوعيَّةً لطبيعة الدراسات الجامعية والبحوث ذات الطابع الأكاديمي. فقد بذل فيها خمسة عشر عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بلدنا المبارك المملكة العربية السعودية جهدًا كبيرًا موفَّقًا؛ قضوا في إعداد رسائله الدكتوراه سنين متواصلة من أعمارهم في قراءة وكتابة آلاف الصفحات مع تحقيق وتمحيص حتى أثمر الجهد وأينعت الثمرة وطبعت سلسلة هذه الموسوعة مشكورة مبرورة: «دار الفضيلة». ولمَّا نظرتُ في جهدهم المبارك رأيت أن من الخير الذي نقدمه للناس ولطلبة العلم أن نضع بين أيديهم هذا المختصر المعتصر من هذه الموسوعة والذي تضمَّن ما يربو على (2800) مسألةً اجتمعت في غالبها عناصر القوة ومعيار تحقق الإجماع الاستقرائي. وقد مهَّدتُّ لهذا المختصر ببحثٍ في (معيار تحقُّق الإجماع)، وختمتُه بـ(إحصائيَّةٍ) تستنطقُ من «موسوعة الإجماع» نتائجَ مهمَّةً يستفيد منها العلماء والفقهاء والأصوليون حيث تجمع عددَ ما لكلِّ عالمٍ من الإجماعات وتحدد ما تحقق منها مما لم يتحقق لتوضح مدى صحة الإجماع وتمثل نتائج واقعية تتسم بالدقة في الجمع والإعداد.
920 صفحة

من المهمات الجليلات التي لا ينبغي الغفلة عنها ولا إهمالها أن يلتفت دارسو كلِّ علمٍ من العلوم -ومن ذلك علم الشريعة- إلى النظر في انتقال هذا العلـم من طبقــةٍ إلـى أخـرى، وفـي رسـوم ذلك وآدابـه وتقاليـده، وقد اجتهـد أهل العلم في تحرِّي أصدق صورة يحصل بها هذا الانتقال. وفيما يتصل بالفقه فمن ضرورات النظر الفقهي بحثُ تاريخ علم الفقه بوجه عام، وبذل الجهد في فهمه، واتباع منهاج دقيق في ذلك، لأن تمام فهم العلم بفهم تاريخ العلم. وهذا الكتاب يضمُّ بين دفَّتيه أربعةَ أبحاثٍ تسهم في تحقيق ذلك وإثرائه، وهي: البحث الأول: حاجة الفقيه من علم التاريخ. البحث الثاني: تحقيب تاريخ الفقه، المفهوم والثمرة. البحث الثالث: قراءة الفقه على الشيوخ، أنواعها وأهميتها وأغراضها. البحث الرابع: الإذن بالإفتاء والتدريس، معناه وصوره. ويجمع هذه الأبحاث أنها سَنَدٌ يَصِلُ الفقيهَ بمَن تقدَّمه، بتحرير استمداد علمه من معين التاريخ، وضبطِ القول في تحقيب مراحله، والكشفِ عن إحكام انتقاله وتوريث مادَّته من خلال أهله المتحققين به القائمين بمدارسه ومذاهبه.
210 صفحة

هذا الكتاب يقصِدُ إلى تقديم أنموذج عال للعبقريَّة العلمية، متجسِّدةً في الإمام الشافعي رضي الله عنه، وذلك بقصد استلهام مكونات عبقريته لاستنبات عبقريَّات أخرى في محيطنا العلمي، فما أحوجَ الأمةَ اليوم إلى قيادات علميَّة عبقرية تحسِنُ أن تتفاعلَ مع واقعها بحكمة ناجزة وخبرة نافذة، مسبوقة بتأصيل علمي مكين وهضم تام للمنجَز المعرفي التراثي، تأتلف في أطروحاتها مكوناتُ العلم والمنهج من جهة، وسمات المعاصرة والتفاعل الحضاري من جهة أخرى، شأنُها في ذلك شأنُ قدواتها التاريخية الملهِمة التي كان لإسهامها قدمُ صدقٍ في الرقيِّ بهذه الأمة
309 صفحة

هذا الكتاب محاولة لاختصار أحداث السيرة النبوية، واختيار الصحيح منها ما أمكن، ولذا جاء اسمه (المختصر من صحيح السيرة النبوية)، وجاءت مصادره في مقدمتها الصحيحان، وكتب السنة، والسيرة، والطبقات والتراجم، والدلائل، إضافة إلى غيرها من المصادر والمراجع. * ومع النقل الصحيح دروس وعبر، ووقفات وتعليقات توحي بها نصوص السيرة ويحتاجها القارئ لهذه السيرة العطرة، فغني عن البيان أن السيرة النبوية للتأسي والاقتداء وليست لمجرد العرض والنظر. * وحين يكون التاريخ بعامة ميداناً لتجارب الأمم، ومستودعاً لأنماط الحياة المختلفة، فإن السيرة في صدارة هذا التاريخ، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم حافلة بأنفع التجارب، وأعظم الأخلاق، وأعلى القيم (وإنك لعلى خلق عظيم).
450 صفحة

لا ريب أن سيرة نبينا محمد ﷺ من العظمة بمكان، كيف لا وقد زكى الله صاحبها وامتدح خُلُقه من فوق سبع سموات ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]، ووصف الله شمائله بأسمى الصفات، ووصفه باسمين من أسمـائه جـل وعـز فقال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، واعتُبرت أخلاقه ﷺ وسيرته معجزةً من المعجزات، بل قال ابن حزم: «لو لم يكن من المعجزات لمحمد ﷺ غير سيرته لكفى». وإذا لم يكن بإمكان أحد أن يضيف على هذه السيرة العطرة فوق ما كتُب عنها من نصوص ومرويات، فإن المجال شَرَعٌ للكتابة عنها والتجديد في عرضها بأكثرَ من وجهٍ وأسلوبٍ، تجليةً لمعالمها وكشفًا لأسرارها. وهذا الكتاب يسهم في ذلك برصد جملةٍ من المعالم والدروس والوقفات المقتبسَة من هذه السيرة الزكية، معتمدًا على ما صح من أحداثها، لتكون دليلًا بين يدي العلماء، والدعاة، والمربين، والمعلمين، والمصلحين، لينهلوا من معين السيرة ما يساعدهم على التعليم والدعوة والتربية والإصلاح.
170 صفحة

<p>كان مما فعله أربابُ البيان أن عمدوا إلى شعر العرب فاختاروا منه ما استحسنوه، اختيارَ حذق ودراية لا تشهٍّ وعَماية، وكان على رأس هذه الاختيارات اختيارُ أبي تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوانه المعروف بـ«الحماسة»، الذي (وقع الإجماعُ من النقاد على أنه لم يتفق في اختيار المقطّعات أنقى مما جمعه) كما يقول المرزوقي.</p> <p>ومن العناية بديوان الحماسة ما تحصّل في عصرنا للشيخ أبي مالك العوضي الذي عمد إلى هذا الديوان فانتخب منه نحوًا من ألفِ بيت للحفظ والاستشهاد، وكانت هذه الألفية بحاجة إلى شرحٍ يكون ذريعةً لتعلق الطلبة والمتأدِّبين بها، ومطيَّةً لتفهُّمها في سبيل حفظها وإنشادها، فكان هذا الكتاب شرحًا يقرّب معانيها للمبتدي ويسهِّل مركبَها للممتطي، يسهِّلُ الأخذَ منها، ويقرِّبُ النظرَ فيها.</p> <p><strong>وانتهج واضع الشرح في ابتداء شرح كلِّ قطعةٍ ذكرَ خبرها ونبأ شاعرها، ثم أردف ذلك ببيان مفرداتها مع ما استتبعتْه من نكاتٍ بلاغيةٍ وأوجهٍ نحوية متى ما اقتضى المقام ذلك، ثم أتبع ذلك بصياغة القطعة نثرًا؛ تيسيرًا للفهم، ولتمرَّ القطعة على القارئ بأكثر من طريق.</strong></p> <p><strong>وكان مما امتاز به هذا الشرح الأثير قرن نظائر الأشعار إلى بعضها، وجمع الأشباه إلى أمثالها، كما تقيَّل ذرى الإحسان بكثرة الاستشهاد بآيات القرآن، ليُعلم بذلك وثيقُ الصلة بين كتاب الله ولسان العرب.</strong></p>
686 صفحة

التسليـم للنص الشرعي ليس مجرد الإيمان بأن القرآن كلام الله وبحجـية سنــة النبي ﷺ الذي يتفق عليه عموم المسلمين، بل هو التزام وانقياد يتبع كمال الإيمان، فيزداد مع زيادة الإيمان، ويضعف مع ضعفه، فكلما زادت في قلب المؤمن الخشية والتعظيم واليقين زاد تسليمه، وكلما ضعفت ضعف تسليمه. والمسلم المعاصر تتدفَّق عليه أمواج الشبهات والمعارضات من كلّ جانب، تمرّ بين عينيه، وتطرق سمعه، وتصارع عقله حتى تشككه في كلّ شيء، وتحشد عليه كلّ ما يزحزح يقينه، وتفتح على قلبه كافة منافذ الحيرة والشكوك، ومن ذلك العوارض والشبهات التي تضعف من درجة تسليمه للنص الشرعي فيسهل عليه رفض حكم شرعي أو تأويل نصّ ما أو تضعيف حديث معين نظراً لعوامل كثيرة تضغط عليه فتؤثر في نتيجة فهمه للنصّ وإن كان صادقاً في اتباع الدليل. وتلك المعارضات كثيرة جدًّا، يستحيل حصرها، وكلما بعد الإنسان عن النصّ كثرت عليه المعارضات، وهي من الابتلاء الذي يمحّص الله به المؤمنين، وفي هذا الكتاب معالجة لأبرز تلك المعارضات، وهي راجعة لخمسةٍ من الأصول الكبرى (العقل، فهم النصّ، الواقع الذي سينزّل عليه النصّ، مقاصد النصّ، الخلاف الفقهي)، وتتسم تلك المعارضات بحضورها في المشهد المعاصر وإن كان كثير منها يعتبر من المعارضات القديمة. وفي هذا الكتاب عرضٌ لمعالم التسليم في كل أصل من هذه الأصول، يتبين فيها منهج التسليم الواجب، ثمّ ظاهرة الانحراف في هذه الأصول عن التسليم للنص الشرعي بفعل المعارضات والإشكالات المختلفة.
350 صفحة

<p>القراءة في السيرة مجرَّدةً نورٌ وبرهان، وحياةُ قلوبٍ، وعلمٌ جمٌّ غزير، لكن الوقوف مع الدروس والعبر، وفقه الموقف والحدث، والتأمل في الدلالات والغوص في الأهداف والغايات = علمٌ أعمقُ غزارةً، وأنفعُ في السلوك والتطبيق، وأكثرُ تحقيقًا لمعاني المحبة والاقتداء.</p> <p>ومن فضل الله عليَّ -وفضائله عليَّ وعلى غيري جلَّ شأنه لا تحصى- أنْ شرَّفني بصحبة هذه السيرة العطرة قراءةً وتدريسًا منذ مدة طويلة.</p> <p>ومن خلال ذلك أحببت فقه السيرة، وعُنِيتُ به، لِمَا رأيت أثره عليَّ أولًا، وعلى من يتلقى الدرس ثانيًا، فصار لي تعلُّقٌ به وتدوينٌ لِمَا يمر عليَّ منه، أثناء التدريس في الجامعة وفي المسجد، فجمعت ما حصَّلتُ في أوراقٍ تحولت إلى كتاب بدأ في عام (1413) ورأى النور عام (1424)، فطُبع طبعات كثيرة بلغت ثنتي عشرَةَ طبعةً بحمد الله.</p> <p>وقد كنتُ في كل قراءاتي –بعد ذلك- في التفسير والحديث والتوحيد والفقه وغيرها، مستحضرًا السيرةَ النبوية وفقهَها؛ رجاء مزيدِ إثراءٍ لكتابي «فقه السيرة» دَائِمَ التعليق والإضافة على نسخة خاصة بذلك، حتى اجتمع لي ما يشجع على إعادة إخراج كتابي مرة أخرى، بطبعة جديدة فيها إضافات <strong>بلغت ضعفَ ما تقدَّم</strong> <strong>تجمَّعتْ خلالَ سبعةَ عشرَ عامًا مضتْ</strong> أقدمه للقراء الكرام في حلة جديدة عن مركز «آفاق المعرفة» في جزأين بعد أن كان في جزء واحد.</p>
1441 صفحة

492 صفحة

غير محدد صفحة

غير محدد صفحة

153 صفحة

وُصِف الشيطان في القرآن الكريم والسنة الشريفة بالقعود، وتكرر هذا الوصف فيهما، وهو قعودٌ يتضمن الرصد والتهيؤ للمكائد، فصار لزامًا علينا أن نتعلم الطرق والوسائل التي يكيد بها الشيطان عدوه الدائم «ابن آدم»، والوحي أطْلَعَنا على كل ذلك، بل أطلعنا على تاريخه القديم وأخباره وأوصافه، ثم أمرنا بأن نتخذه عدوا. ولذلك وجب على المؤمن أن يعرف عدوه إبليس، وأن يعلم تاريخه ومسالكه وحبائله، قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنَّى تأتيه». وأنْ يجتهد في مقاومته ومدافعته في كل تلك المسالك، وأن يجعل ذلك أولوية في حياته، وألا يتساهل في حملِ سلاحه ضده والتحصنِ من عدوانه، فإن كثيرين يغفلون عن عداوته، وبعض الناس يظن أن كيده مقصور على الوسوسة أو ما يتعلق بالسحر، فيغفلون عن حقيقة المعركة بينهم وبين الشيطان. وهذا الكتاب يؤلف من نصوص القرآن والسنة صورةً شموليَّةً لهذه العداوة، من حيث المضمون والأدوات، بطريقة موجزة ومفيدة، ترسم لدى القارئ الكريم صورة جلية لأبعاد معركتنا مع الشيطان.
204 صفحة

العمر الذاهب رحلة المازني المعرفية من القراءة إلى الكتابة هذه سيرةٌ معرفية فاخرة من طرازٍ غير ما تألَف، جمعَت حلاوة البيان إلى ظرف الروح إلى حكمة العمر، فيها عبرةٌ وتجربة، ومتعةٌ وفائدة، وألوانٌ معجبة من الصَّراحة النادرة، ورفعٌ رقيقٌ للحجاب عن أسرار نفس إنسانية قلقة، ومشاهدةٌ لها من قريب، بقلم صَنَاع حاذق، أحسن الإبانة عنها، وافتنَّ في كشف دخائلها، متأثرًا بما أطال صحبته من قصص الروس ورواياتهم، وإن أثرها فيه لكبير. سيرةٌ لا ينقصها الصدق الذي ينقص كثيرًا من السير الذاتية، بل هي مرآةٌ كاشفةٌ لروح صاحبها في رضاه وغضبه، وغروره وتواضعه، وفرحه بما قدَّم وندمه على ما فـرَّط، يخطئ فيعترف، ويُحْسِن فيتباهى، لا يعبأ برأي القارئ فيه، ولا يلتفت لموقف العالم منه، وقد هان عنده كلُّ شيء حتى ما يحفل شيئًا، أو يبالي كيف يكون، أو يتحسَّر على شيء فات، أو يتطلَّع إلى ما هو آت، كما يقول عن نفسه. ومن ترى من الأدباء الكبار يجسُر على الاعتراف بأنه لا يفهم الفلسفة، أو الإقرار بأنه يعيد قراءة الأدب العربي مرة أخرى لأنه تعجَّل في قراءته أول مرة، أو التصريح بأنه يكتب للخبز لا للأدب، أو المجاهرة بترك الشعر وقد كان معدودًا من شعراء عصره لأنه رأى نفسه ليس من أهله؟ ومن منهم تسمح نفسه بالاعتراف بالفضل في توجيهه لواحدٍ من أقرانه، بل من خصومه وأعدائه؟ دعك من كبار الأدباء، كم من عامة الناس من يعترف بأخطائه ويتراجع عن حماقات شبابه؟ ومفاجآت المازني التي ستستقبلها في هذا الكتاب لا تنتهي!
368 صفحة

التكامل بين أصول الفقه والعقيدة ظاهر في كل المصنفات المتقدمة؛ فما أن تقرأ كتابًا عقديًّا إلا وقواعد الأصول ظاهرة فيه تارة بالتصريح وأخرى بالإشارة، كما أنك لا تجد كتابًا أصوليًّا إلا وأصوله لها تعلق بأصول الدين، تارة تكون مباشرة وأخرى غير مباشرة، ومن هنا كثرت الأبحاث والدراسات الواسعة المعاصرة في هذا، لما له من مادة واسعة في كتب المتقدمين. وهذا الكتابُ يقدِّمُ صورةً مثلى للتكامل المعرفي بين هذين العلمين، وذلك بإحياء الأصول المتداخلة بينهما من خلال تقرير ركنَي البناء والحفظ والأصول المكونة لكلٍّ منهما: فأما البناء فتكوِّنه ثلاثة أصول، وهي: (الأحدية، البرهنة، الغائية). وأما الحفظ فتكوِّنه أربعة أصول، وهي: (نفي التناقض، رد البدع، رفع المتشابهات، سد الذرائع). وقد تناول الكتاب بيانَ تلك الأصول وأضاء الجوانبَ البحثية المتصلة بها.
140 صفحة

318 صفحة

يعد موضوع العلاقة بين الشريعة الإسلامية والعلوم الاجتماعية -خاصة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا- من المجالات البينية المثيرة للجدل والتي بحاجة لتأصيلات تتطلب إلمامًا بمقدمات عديدة، ويهدف هذا الكتاب إلى دراسة وتحليل المقاربات السوسيولوجية للشريعة، وتحرير أصول مقولات التكامل بين الشريعة وهذه العلوم الاجتماعية. يقدم القسم الأول من الكتاب تحليلًا للمقاربات السوسيولوجية والأنثروبولوجية للشريعة، إلى جانب تحرير الأصول الإبستمولوجية لمقولات التكامل بين العلوم ومنتهى آفاقها، مع الكشف عن أوجه القصور في هذه المقاربات، مشيرًا إلى أن الشريعة منظومة معرفية لها أدواتها الخاصة، وأن القول بإمكانية فهمها بالكامل من خلال الأدوات والمفاهيم التي يستخدمها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا قد ينتج عنه اختزال الشريعة إلى مجرد ظواهر اجتماعية أو ثقافية. وأما القسم الثاني، فهو مخصص للنقد الإبستمولوجي (المختلف عن النقد الطبيعاني والمادي) لعلم الاجتماع الغربي، مسلطًا الضوء على أصوله الاستعمارية والمركزية الأوروبية التي تشكل جزءًا من جذوره الفكرية والمنهجية. يبرز الكتاب التناقضات الأساسية بين الشريعة الإسلامية، التي تعتمد على الوحي والتشريع الإلهي، وعلم الاجتماع الغربي الذي يعتمد على منهجيات علمانية وفكرية تنبع من خلفيات ثقافية وسياسية محددة، ومن خلال هذا النقد يدعو الكتاب إلى إعادة التفكير في كيفية دراسة المجتمعات الإسلامية والشريعة بعيدًا عن التأثيرات الاستعمارية والفكرية الغربية. الفهرس والمقدمة
266 صفحة

209 صفحة

تعيش البشرية اليوم على وقع نقلة بعيدة، تقودها ثورة تكنولوجية هادرة تغلغلت في مسارب الحياة الإنسانية بكافة تنويعاتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، سواء في ذلك الفرد والمجتمعات، لم ينجُ مجال تقريبًا من أن يمسه طائف الثورة الرقمية. أصبحت العوالم الافتراضية عالمًا موازيًا لحياتنا الواقعية ويوشك أن يحل محلها فتتلاشى الفواصل بين الواقع والافتراضي. في هذه العوالم الافتراضية اقتصاد جديد قائم على عملات جديدة، والاستثمار في عقارات ومبان وأسواق افتراضية. في هذه العوالم الافتراضية من الممكن أن ستذهب أنت وتبقى شخصيتك الإلكترونية التي منحتها ذكرياتك وآراءك وحتى حياتك الشخصية بعد مماتك ربما لقرون طويلة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة: - ما الذي تحمله لنا هذه التكنولوجية الحديثة في طياتها؟ - ما تأثيراتها المستقبلية على واقع المجتمعات حيث ستتلاشى الحواجز بين الدول والكيانات والمجتمعات البشرية؟ - هل نستطيع أن نورث أبناءنا قيمنا وثقافتنا في ظل هذا العالم المنفتح؟ - ما مستقبل عالم الاقتصاد والأعمال في ظل عملات جديدة، حيث مئات الوظائف ستنقرض وأخرى ستظهر حديثا؟ - كيف نستفيد من هذه التكنولوجيا وكيف سنتجنب أضرارها؟ - هل تمثل تلك الثورة التكنولوجية الجديدة مجرد فقاعة سرعان ما تنفجر، أم آن أوان التهيؤ لمعطياتها الجديدة؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عليها من خلال هذا الإصدار التاسع عشر من التقرير الارتيادي والذي هو بعنوان (ما بعد الإنسانية .. العوالم الافتراضية وأثرها على الإنسان).
318 صفحة

عالج الرافعيُّ الشعر، وكابد لأواء قوله، ثم تصدى لنقده وفلسفته، فكان بصيرًا به، عارفًا بمنازعه، خبيرًا بتمييز جيده من رديئه، افتنَّ في الكشف عن أسراره والتدسُّس إلى خوافيه، ونصب الموازين للشعراء، يحاسبهم بمثاقيل النغم، ويحصي عليهم هفوات الحرف وعثرات الذهن وكبوات القوافي، ويدلُّ مقتدرًا على مواضع إحسانهم ومواطن زللهم، ببيان عالٍ، وحجَّة حاضرة، وظرفٍ مطبوع، وأخذٍ يترفَّق تارة ويبطش أخرى. يستمدُّ ذلك من علم غزير بالتراث البلاغي، ومن اطلاع واسع على كتب صناعة الشعر ونقده، ومن إلمام مفصَّل بتاريخ الأدب العربي في أدواره المختلفة، ويتكئ على ذاكرة سخيَّـة واستحضارٍ مدهش، وعلى ذكاء لمَّاح يتنبَّه لخفيِّ المآخذ ويهتدي إلى دقيق السَّرقات ويقرأ ما لا تقرؤه الأعين المتعجِّلة، ويمتحُ من بصر نافذ إلى روح الشعر وما ينبغي أن يكون عليه، ويقاتلُ بسيفٍ صمصام من الموهبة والاستعداد الفطري المتوقد. فلا جرم أن يكون تراثه في هذه الأبواب متعةً للروح، وغذاءً للعقل، وصقالًا للذوق، وصونًا للقريض من عجمة اللسان وعيِّ الفكر واضطراب الرأي. وفي هذا الكتاب جمهرة مقالات الرافعي ومقدمات دواوينه وجنوده وبنوده في صون القريض والذود عن عموده، فلسفةً لحقيقته، ودراسةً لبعض شعرائه، ونقدًا لما لم يستقم منه على طريقته، جمعتها من كتبه المنشورة، وهي الأقلُّ، وممَّا ترك من تراث ما زال جزءٌ منه مطويًّا في بطون المجلات والصُّحف لعهده، وهو الأكثر. ومن نماذج النصوص المندثرة التي أحيا الكتابُ مواتها وتنشر أول مرة في كتاب: مقال «الشعر العربي» وهو أول ما وصلنا من مقالات الرافعي طرًّا، نشره في مجلة «المنار» وهو في العشرين من عمره، ومقال «الموازنة بين أبي تمام والبحتري والمتنبي»، ومقال «إمارة الشعر»، ومقالات نقد «القصيدة العُمَرِيَّـة» لحافظ، وغيرها.
424 صفحة

يحاول هذا الكتاب أن ينبش عميقًا في التغيير الذي أحدثه المشروع الحديث في سلَّم الأولويات والقيم، وكيف رسّخت مقولاته المركزية -كالحرية ونفي المقدس وسيولة الهوية- النتائج الحالية التي وصل إليها تطبيع المثلية، والسياقات التاريخية لهذه المقولات. لا يتوقف الكتاب على تتبع جذور تطبيع المثلية إلى المقولات الحداثية الأوسع، بل يدلف بشيء من التعمق إلى المقولات الخاصة بالهويات والميول الجنسية التي عززت من ذيوع ومأسسة وقبول المثلية والدفاع عنها مثل مقولات الجندر والكوير. من جانبٍ آخر، يفحص الكتاب السياق التاريخي الذي تشكلت فيه هذه المقولات، وكذلك المراحل التي مرت بها المثلية في سياق المجتمع الغربي، ثم يعرّج على آليات توفيد تطبيع المثلية في الفضاءات الإسلامية وآليات تأويل وتكييف التراث الديني (المسيحي في الماضي، والإسلامي في الحاضر) لكي يستوعب هذه الممارسات.
224 صفحة

منذ القرن التاسع عشر، لم تتوقف الأكاديميات الغربية عن نشر الأبحاث والدراسات الاستشراقية حول الشريعة الإسلامية والفقه وأصوله، حتى شكّل مجموعُ هذه الأبحاث السردية الاستشراقية حول الشريعة والفقه بشكل عام والتي عملت على تشكيل وتوجيه الغالبية العظمى من نمط الكتابة والبحث في تاريخ وآليات اشتغال الشريعة الإسلامية والفقه وأصوله. وهذا الكتاب يسعى إلى رسم الخريطة العامة للاشتغال الاستشراقي حول الشريعة، واستخلاص وتحليل ومناقشة معالم السردية الاستشراقية حول الشريعة من خلال النصوص المركزية التي يعوّل عليها عامة الباحثين الغربيين في بناء تصورهم عن الشريعة، وذلك بغية الوقوف على نقاط الوفاق والخلاف وأنماط الاستمرارية فيما بينها. وقد كان لطرح الدكتور وائل حلاق حول الشريعة الإسلامية موقعٌ خاصٌّ من هذا الكتاب، باعتباره المشروع الأحدث في هذا الصدد، ولأنه يستهدف تفكيك منطلقات السردية الاستشراقية حول الشريعة، وذلك من خلال الوقوف على معالم هذا الطرح وتقييم مخرجاته في ضوء النتائج الواقعية التي انتهى إليها.
352 صفحة

عايش المؤلف مواقف شتَّى، في محاوراته وفي أثناء تدريسه لطلبةٍ متفاوتي السنّ ومختلفي الخلفيات العلمية، وواجه في ضمن ذلك سؤالاتٍ متصلةٍ بأصول الإسلام ودلائل تثبيته، وكان من آثار ذلك أنْ ترسَّخ لديه حاجةُ كلِّ مسلم وخاصَّة الشَّباب والفتيات للأسئلة المركزيَّة، وتحديدها، وتصويب النَّظر إليها، ثمَّ محاولة الإجابة عليها من زوايا عدَّة، لتطمئنَّ القلوب، وتسكن الأرواح، ويصل المسلم بتلك الأجوبة إلى الرضى بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ رسولًا، والرضى بذلك هو (جنة الدنيا ومستراح العارفين) كما يقول ابن القيم، فكان هذا الكتاب يسيرًا في مبناه، عميقًا في مغزاه، قاصدًا إلى تثبيت أصول الدِّين في القلوب، وتعزيز اليقين بأصول الإسلام، وإظهار مطابقة العقل السَّليم لأصول الإسلام ومفاهيمه، وبناء الأدلَّة وترتيبها في ذهن المسلم، وبذلك يكون المرء متحقِّقًا بدين الإسلام الذي هو صبغة الله وفطرته التي فطر الناس عليها.
114 صفحة